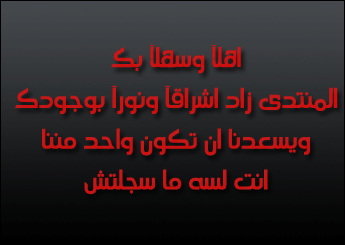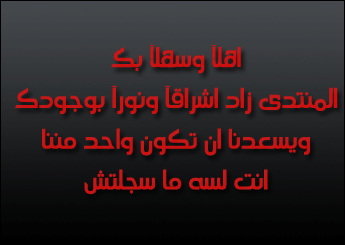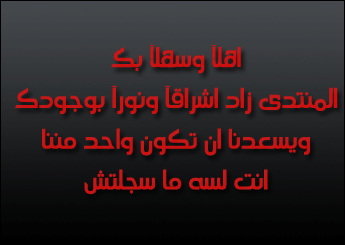لا يكاد المتأمِّل في التراث العربي الإسلامي يحاول ارتياد مجاهل واقتحام شيء من معاقله حتى يهوله هذا الأوقيانوس المهيب.
كان الإسلام حدث الأحداث في تاريخ الجزيرة العربية وحياتها. فقد تلقّى العرب إيمانهم الجديد فكانوا له مهيّئين، لذا أنشأوا وجهة نظر خاصّة بهم ومقبولة في كل معايير العقل والمنطق: كوّنوا وجهة نظرهم في ما يخصّ الإيمان والإنسان والكون والحياة والمصير والمعاد والمآل.
آمنوا بالتوجيه القرآني بأن ما من شيء وجد عبثاً، وإنّما كل شيء مخلوق بقدر. ومن كلام للجاحظ، يعدّ في أعلى مراتب البلاغة والحكمة، حيث يقول: "إنّ المصلحة، في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها، امتزاج الخير بالشر، والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفاً هلك الخلق، أو كان الخير محضاً سقطت المحنة، وتقطعت أسباب الفكرة. ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة. ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالِم تثبُّت وتوقُّف وتعلُّم. ولم يكن علم. ولا يعرف باب التدبير، ودفع المضرة، ولا اجتلاب المنفعة، ولا صبر على مكروه، ولا شكر على محبوب، ولا تفضال في بيان، ولا تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفر، وعز الغلبة، ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق، ومبطل يجد ذل الباطل، وموفق يجد بَرد التوفيق، وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم، ولم تكن للنفوس آمال ولم تتشعبها الأطماع.. فسبحان مَن جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع.. وجعل في الجميع تمام المصحلة وباجتماعها تمام النعمة".
والإنسان مقياس كل شيء ومعياره على حد قول بروتاجوراس (430 قبل الميلاد). العرب المسلمون أدركوا هذا بفطرتهم وذكائهم وطبّقوه علماً وعملاً وتمّ لهم ذلك أكثر بوازع من دينهم الجديد. أدركوا أنّ الإنسان إنّما هو في واقع وجوده امتداد خارج حدود ذاته ليتدبّر عظمة هذا الكون وأعظم منه عظمة خالقه: "فالكون بغير الإنسان ليس سوى كتلة موات من المادة والحركة لا تعني في ذاتها شيئاً على الإطلاق. فهو ليس خيراً ولا شرّاً، ولا صواباً ولا خطأً، ولا حقاً ولا باطلاً، لا جميلاً ولا قبيحاً، وليس مؤذياً ولا ناقصاً، ولا قديماً ولا حداثاً، ولا تافهاً ولا رائعاً، ولا موضوعاً لمدح ولا موضوعاً لذم، بل ليس موجوداً وليس غير موجود.. بالفكر، بالإنسان، باحتياجات الناس وعلائقهم، بمصالحهم وآمالهم وآلامهم، بمباهجهم ومآسيهم، برصاناتهم ومهازلهم، بأمانيهم وحسراتهم، بحقائقهم وأوهامهم وسخافاتهم وأساطيرهم.. صارت هذه الكتلة من المادة والحركة جميلة أو قبيحة، مفيدة أو ضارّة، منتظمة أو مختلّة، معقولة أو سخيفة، حادثة أو قديمة، مقبولة أو مرذولة.. وهناك من الأحكام على هذه الكتلة بقدر ما هنالك من مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء وشعراء فيهم المتفائل والمتشائم، والمؤمن والملحد، والقائل بالنظام والتدبير والمنكر لكل نظام وتدبير، والمتشيِّع للمعقول، والمتحمِّس لغير المعقول. وكل حزب بما لديهم فرحون! وهكذا اختلفت الأحكام والأنظار وتباينت وجوه الرأي والإجتهاد. كلٌّ يعمل على شاكلته.. ليست المسألة هي مسألة كون وكفى، وإنّما المسألة هي مسألة كون هو مسرح للإنسان ومجال للإنسان وتحقيق أغراض الإنسان. إنّها مسألة إنسان يبحث عن امتداد له خارج ذات الإنسان لتحقيق معنى الإنسان. فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان" (محمد عبدالرحمن مرحبا، الفكر العربي في مخاضه الكبير، منشورات عويدات، بيروت، 1982، ص224-225).
إنّ نظرة العرب المسلمين إلى آفاق حياتهم الجديدة نظرة تفاوتت فيها أحكامهم. لكن كان هناك قدر مشترك لدى الجميع أخذهم الإعجاب به والسبك على منواله، لذا جاء تراثهم حافلاً بروح القرآن إيماناً، وأدباً، وعلماً، وتربية.
فالبحث المقارن بين المحسنات اللفظية في الأدب العربي والمحسنات البديعية في القرآن، ينتهي إلى استغلاق معاني المحسنات اللفظية في الأدب العربي أحياناً عندما تراد لذاتها: "أمّا ما ورد في القرآن مما نعدّه محسنات بديعية، فقد وردت الألفاظ التي كان بها هذا الحسن البديعي في مكانها، يتطلبها المعنى، ولا يغنى غيرها غناءها.
خذ ما ورد في القرآن الكريم من الجناس التام، كقوله تعالى: (... يَكَادُ سَنَا بِرقِهِ يَذهَبُ بِالأبصَارِ * يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيلَ والنَّهارَ إنّ في ذلكَ لَعِبرَةً لأُولِي الأبصار)، تجد كلمة الأبصار الأولى مستقرة في مكانها فهي جمع بصر، ويراد به نور العين الذي تميز بين الأشياء وكلمة الأبصار الثانية جمع بصر بمعنى العين، ولكن كلمة الأبصار هنا أدل على المعنى المراد من كلمة العيون، كما أنّها تدل على ما منحته العين من وظيفة الإبصار، وهي التي بها الموعظة والإعتبار، فأنت ذا ترى أنّ أداء المعنى كاملاً، تطلب إيراد هذه الكلمة، حتى إذا وردت رأينا هذا التناسق اللفظي.
واقرأ قوله تعالى: (ويَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقسِمُ المُجرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيرَ ساعَةٍ...) فكلمة (الساعة) الأولى جيء بها دالة على يوم القيامة، واختير لذلك اليوم هذا الإسم هنا، للدلالة على معنى المفاجأة والسرعة، وكلمة (ساعة) الثانية تُعبِّر أدق تعبير عن شعور هؤلاء المجرمين، فهم لا يحسبون أنّهم قضوا في حياتهم الدنيا برهة قصيرة الأمد جداً، حتى يُعبِّروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلاً، ولا بفترة طويلة، يعبِّرون عنها بيوم مثلاً، فكانت كلمة (ساعة) خير معُبِّر عن شعورهم بهذا الوقت الوجيز.
وما ورد في القرآن من جناس ناقص، فسبيله سبيل الجناس التام، وانظر إلى قوله تعالى: (وَهُمْ يَنهَونَ عضنهُ ويَنأَونَ عَنهُ وإنْ يُهلِكُونَ إلا أنفُسَهُم وَما يَشعُرُون)، ألا ترى أنّ موقف الكفار من القرآن، أنّهم يبعدون الناس عنه، كما يبعدون أنفسهم عنه، فعبَّر القرآن عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قربهما بقرب معنييهما.
ويطول بي القول إذا أنا مضيت في بيان كيف حلّت كل كلمة في جمل الجناس محلها، بحيث لا تغني كلمة أخرى في هذا الموضع غناءها، وحسبي أن أشير إلى تلك الآيات، التي ورد فيها ما كون بعض ألوان من الجناس، مثل قوله تعالى: (فأمّا اليَتِيمَ فَلا تَقهَر * وأمّا السَّائِلَ فَلا تَنهَر)، وقوله تعالى: (وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلى رَبِّها ناظِرَة)، وقوله: (والتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إلى رَبِّكَ يَومَئِذٍ المَسَاقُ)، وقوله سبحانه: (ولَقَد أرسَلنا فِيهِم مُنذِرِين * فَانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُنذِرِين).
فأنت ترى النهي عن القهر جاء إلى جانب اليتيم، بمعنى الغلبة عليه والإستيلاء على ماله. وأمّا السائل، فقد نهى عن نهره وإذلاله، فكلا الكلمتين جاء في موضعه الدقيق، كما وردت كلما ناظرة وناضرة أي مشرقة، وإشراقها من نظرها إلى ربّها، وقد توازنت الكلمتان في جملتيهما، لما بينهما من صلة السبب بالمسبب. واختيار كلمة المساق في الآية الثانية لتصور هذه الرحلة التي ينتقل فيها المرء من الدنيا إلى الآخرة، فكأنّه سوق مسافر ينتهي به السفر إلى الله. وفي كلمة المنذرين ما يشير إلى الربط بينهم وبين المنذرين الذين أرسلوا إليهم.
وقل مثل ذلك في قوله تعالى: (وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة)، فإنّ شدّة التشابه بين الكلمتين يوحي بالقرابة بينهما، ممّا يجعل إحداهما مؤكدة للأخرى فالهمزة المغتاب، واللمزة الغياب، فالصلة بينهما وثقى، كالصلة بين الفرح والمرح في قوله تعالى: (ذلِكُم بِمَا كُنتُم تَفرَحُونَ في الأرضِ بِغَيرِ الحَقِّ وبِما كُنتُم تَمرَحُون).
وإيثار كلمة النبأ في قوله سبحانه: (... وجِتُكَ مِن سَبَأ بِنَبَأ يَقِين) لما فيها من معنى القوة، لأن هذه المادة تدلّ على الإرتفاع والنتوء والبروز والظهور، فناسب مجيئها هنا، ووصف النبأ تأكيداً لقوته باليقين.
ويعدون من أنواع البديع المشاكلة، ويعنون بها ذكر الشيء بغير لفظه، لوقوعه في صحبته، ويمثلون لذلك بقوله تعالى: (وجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُها...)، قالوا: فالجزاء عن السيِّئة في الحقيقة غير سيِّئة، والأصل وجزاء سيِّئة عقوبة مثلها. وبقوله تعالى: (ومَكَرُوا ومَكَرَ اللهُ واللهُ خَيرُ المَاكِرِين)، والأصل أخذهم بمكرهم. وبقوله تعالى: (... فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ ما اعتَدَى عَلَيكُم...)، قالوا: والمراد فعاقبوه، فعدل عن هذا، لأجل المشاكلة اللفظية. ولكنني أرى القرآن أجل من أن يُسمِّي الشيء بغير اسمه لمجرّد وقوعه في صحبته، بل أرى هذا التعبير يحمل معنى، وجيء به ليوحي إلى القارئ بما لا يستطيع أن يوحي به ولا أن يدل عليه ما قالوا إنّه الأصل المعدول عنه، فتسمية جزاء السيِّئة سيِّئة، لأنّ العمل في نفسه سوء، وهو يوحي بأن مقابلة الشر بالشر، وإن كانت مباحة، سيِّئة يجدر بالإنسان الكامل أن يترفّع عنها، وكأنّه بذلك يشير إلى أنّ العفو أفضل وأولى، وعلى هذا النسق تماماً ورد قوله: (... فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم...). وأمّا مكر الله، فإن يفعل بهم كما يفعل الماكر، يمدّهم في طغيانهم يعمهون، ثمّ يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
وعدوا من ألوان البديع الإستثناء، ومثلوا له بقوله تعالى: (... فَلَبِثَ فِيهِم ألفَ سَنَةٍ إلا خَمسِينَ عَاماً...). وفي هذا التعبير، فضلاً عن إيجازه، إيحاء بطول المدّة، وتهويل للأمر على السامعين، وفي ذلك تمهيد العذر لنوح في الدُّعاء على قومه، وذلك لأن أوّل ما يطرق السمع ذكر الألف، فتشعر بطول مدّته، وتتصوّر جهاد نوح في ذلك الزمن المديد، ولن يقلِّل الإستثناء من شأن هذا التصور، ولا يتحقق هذا الإحسان إذا بدأت بغير الألف.
وما ورد في القرآن من طباق بالجمع بين المتضادين، كانت الكلمة فيه مستقرة في مكانها تمام الإستقرار، سواء كان التضاد لفظاً أو معنى، حقيقة أو مجازاً، إيجاباً أو سلباً، كقوله تعالى: (وَمَا يَستَوِي الأعمَى والبَصِيرُ * وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّور)، فأنت تراه يعقد الموازنة بين هذين الضدّين ولا مفرّ من الجمع بينهما في الجملة لعقد هذه الموازنة التي تبيِّن عدم استوائهما، كقوله تعالى: (وأنّهُ هُوَ أضحَكَ وأبكَى * وأنّهُ هُوَ أماتَ وأحيَا)، وقوله سبحانه: (وتَحسَبُهُم أيقَاظاً وَهُم رُقُود...).
ومن الطباق السلبي، قوله تعالى: (... قُل هَل يَستَوِي الذينَ يَعلَمُونَ والذينَ لا يَعلَمُون...)، وقوله: (... فَلا تَخشَوا النّاسَ وَاخشَونِ...). ومن الطباق المعنوي قوله تعالى: (... إنْ أنتُم إلا تَكذِبُونَ * قالوا رَبُّنا يَعلَمُ إنّا إليكُم لَمُرسَلثون) أي إنّا لصادقون، فإنّ الرسول يجب أن يكون صادقاً.
ومن ألوان البديع العكس بأن يُقدِّم في الكلام جزء، ويؤخِّر آخر، ثمّ يقدِّم المؤخر ويقدِّم لمقدم، وجمال العكس في أنّه يربط بين أمرين، ويعقد بينهما أوثق الصلات أو أشد ألوان النفور، تجد ذلك في قوله سبحانه: (... يُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويُولِجُ النَّهارَ في اللَّيل...)، وقوله تعالى: (يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ ويُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ...)، وقوله سبحانه: (... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُم وأنتُم لِباسٌ لَهُنَّ...)، وقوله تعالى: (... لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ...)، وقوله تعالى: (... ما عَلَيكَ مِن حِسابِهِم مِن شَيءٍ وَما مِن حِسابِكَ عَلَيهِم مِن شَيءٍ...).
ومن أجمل أنواعه، ائتلاف المعنى مع المعنى بذكر الأمور المتناسبة بعضها إلى جانب بعض، كقوله سبحانه: (قالَ إنّما أشكُو بَثِّي وحُزنِي إلى اللهِ...)، وقد يخفى في بعض الأحيان وجه الجمع بين المعنيين، كما في قوله سبحانه: (إنّ لَكَ ألاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعرَى * وأنّكَ لا تَظمَأُ فِيهَا وَلا تَضحَى)، فقد يبدو أنّ الوجه الجمع بين الجوع والظمأ، والعري والضحاء، ولكن التأمُّل الهادئ يدل على أنّ الجوع والعري يُسبِّبان الشعور بالبرد فجمعا معاً، والظمأ والضحاء يُسبِّبان الشعور بالحر، إذ الأوّل يبعث التهاب الجوف، والثاني يلهب الجلد، فناسب ذلك الجمع بينهما.
هذا ولست أرمي هنا إلى حصر ما عثر عليه العلماء من ألوان البديع في القرآن، فقد تكفّل بذلك غيري، وأفرد ابن أبي الإصبع لذلك كتاباً عدَّد فيه هذه الألوان ومثَّل لها، وذكر من ذلك أكثر من مائة نوع، وكل ما قصدت إليه هو بيان أن ما نشعر به من جمال لفظي حيناً ومعنوي حيناً آخر، لم يأتِ إلا من أنّ اللفظة القرآنية قد استدعاها المعنى، ولم يكن ثمة لفظة أخرى تغني غناءها، فلمّا استقرّت في مكانها زاد بها الكلام إشراقاً، والمعنى وضوحاً وجلاء" (أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، دار النهضة بمصر، القاهرة، 1977، ص181-186. وينظر أيضاً: الدكتور مصطفى عبده، الدين والإبداع، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999، الطبعة الثانية).
اجتهد العرب المسلمون في أُمور دينهم ودنياهم. اجتهدوا فقهاً، وأدباً ولغةً، وتصوفاً، وفلسفةً، وحكمةً، وعلماً؛ بيد أنّ اجتهادهم ذاك لم يكن ليبلغ بهم مبلغ الشنآن، ولم يكن ليخرجهم عن اتزان جوهر الإيمان. فما اشتطوا عمّا أرادهم دينهم الحنيف أن يكونوا عليه من تآخٍ في الله وتصافٍ في الإنسانية جمعاء.
وإذا كانت نشبت بينهم حينذاك خلافات في الإجتهاد تخصّ المسائل الفقهية أو العلمية أو الدنيوية، فإنّما كانت خلافات مردّها إلى قيمة بعض الآراء التي يجب أن تخضع لقواعد المقررات الإسلامية.
كان يتعلّم بعضهم من بعض، ويأخذ بعضهم من بعض بروح سماحة الإسلام، لذا سمت أخلاقهم ونمت إبداعاتهم، وخلد تراثهم.
فما أحوجنا اليوم إلى التمثل بسجاياهم تلك!
ويا ليتنا نشبّث بتراثهم وعلمهم لنسهم بشيء من إبداع تجديد الحياة!
* * *
إنّ الناس في عصرنا هذا فتنتهم الحياة وضروراتها العاجلة، وتعلّقوا بها تعلّقاً سدّ عليهم منافذ النظر إلى شيء آخر أسمى وأخلد. وليس في هذا ما يدهش، فإنّ الله أخبرنا في كتابه أنّه هكذا خلق الناس، وأنّ امتحانهم لإحراز الكمال أساسه تهذيب هذه الطبيعة وامتلاك زمامها، لا الإستسلام والإنقياد لأهوائها: "زين الناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب".
لكن الذي يروع في عالم اليوم أنّ العقل البشري تقدّم تقدماً ساحراً في الميدان العلمي والصناعي، تقدماً أثار في الإنسان الزهو والغرور..
وفي الوقت الذي ظفر فيه العقل، وطوى المراحل الشاسعة، بقيت الخصائص الإنسانية الأخرى جامدة كما كانت في بدء الخليقة.
فالحقد القاتل في قلب ابن آدم نحو أخيه الطيب بقي كما هو مشتعل الأثرة غبي الوجهة.
أمّا الجهل القديم بطريقة مواراة الجثة، فقد تحوّل إلى ذكاء وخبرة..
واليوم استطاعت الإنسانية أن تسخر أعظم ثمرات الإرتقاء العلمي لبلوغ أخس نزعاتها.
ألا ليت الإنسان ارتقى قلباً وعقلاً، وليته رنا بطرفه إلى السماء، كما ملك قياد الأرض؟
إنّه بدلاً من ذلك مضى في طريقه يعبد الحياة الدنيا وحدها ويجهل أو يجحد ماوراءها، ويتطاول على خالقه، ويظن نفسه إلهاً يخطو على التراب...".
ويتمثّل الغزالي بقول (ألكسيس كاريل): "فلأوّل مرّة في التاريخ أصبحت الإنسانية، بمساعدة العلم، سيِّدة مصيرها.. ولكن هل سنصبح قادرين على استخدام هذه المعرفة لمصلحتنا الحقيقية؟ يجب أن يعيد الإنسان صياغة نفسه حتى يستطيع التقدّم ثانية.. ولكنه لا يستطيع صياغة نفسه من غير أن يتعذّب.. لأنّه الرخام والنحات في وقت واحد.
ولكي يكشف عن وجهه الحقيقي يجب عليه أن يُحطِّم مادته بضربات عنيفة من مطرقته. ولكن الإنسان لن يستسلم لمثل هذه المعاملة، أللهمّ إلا إذا دفعته الضرورة لذلك دفعاً.. ذلك لأنّه مادام محاطاً بأسباب الرفاهية والجمال ومعجزات (الميكانيكا) التي أوجدتها (التكنولوجيا) فسيبقى عبد نفسه، ومن ثمّ فإنّه لن يدرك كم هي عاجلة وملحّة تلك العملية.. إنّه يفشل في إدراك أنّه ينحل، بل إنّه يتساءل: لماذا يجب عليه أن يجاهد لتعديل وسائل حياته وتفكيره؟".
فالإنسان بطبعه متأثر ومؤثر، فهو في عملية دائبة لا تقف عند حد عندما يستحصد العزم ويكتمل الوعي الذاتي، وبعدما يستكمل مستلزماته من اللغة والعلم ويستجلي ما يرمي إليه من أهداف يتوخّاها في الحياة.
فالعرب المسلمون استوعبوا فضائل دينهم فاستشعروا الثقة في وجودهم، وآنسوا اليقين في نفوسهم، فتأهّبوا لتحمّل مسؤولياتهم الجديدة، فنهضوا بأعبائهم العتيدة، لذا لهم الصعائب دانت، ولإراداتهم استكانت.
إنّ كل ما في تراث الإسلام، وتراث الإنسانية مجتمعة، من بصائر تنادينا لإستخلاص العِبَر، واستجلاء الخبر، من أجل إسعاد أنفسنا، وإسعاد غيرنا، كما فعل أولئك العظام الذين خلّدوا لنا وللإنسان أينما كان، ثروة فكرية وحضارية لا تقدَّر بكنوز.
لكن السؤال الملحاح: ماذا نحتاج الآن؟
"إنّنا نحتاج إلى علم تدرَّس فيه طرق تحويل الحقائق الدينية النظرية إلى خلق لازم، وعمل دائم، وأسلوب في الحياة معروف الهدف، منسوق الخطوات.
ولن نستغني عن الإحاطة بخبرات الآخرين، وكيف قاوموا الشهوات؟ وأزاحوا العوائق؟ وكيف طبّقوا ما تعلّموا على الواقع؟ وكيف نجحوا في الوصول إلى ما يريدون؟
إنّ الجيوش تحوّلت علومها النظرية إلى مناورات حيّة حتى تستكمل ثقافتها العسكرية. وأنّ المدرِّسين يتدرّبون على القيام بمهنتهم تحت إشراف يعالج القصور ويداوي الأخطاء، قبل أن يباشروا تعليم تلامذتهم في شتى المعاهد.
والمقصود من هذا كلّه نقل المرء من تفكير خيالي إلى تفكير واقعي..
ومن الآفات الملحوظة في ميدان التديُّن أن تقترن العبادة بالجهل، أو بنقص المعرفة وضيق الأفق..
وهذا الفريق من العباد القاصرين تنتشر بينه البدع والخرافات، ويتسم غالباً بالإخلاص الطائش والحماسة الرعناء..
وربّما كان أنقى قلباً وأسلم عقبى! لكن الأُميّة لا يصلح بها دين ولا ينجح بها شعب.
علاج هؤلاء مزيد من المعرفة، وتفتيق الذهن، وتوسيع منادح النظر.
أمّا الآفة التي أزرت بالدين وأهله من قديم، فهي أن يكون المرء على حظ حسن من الدراسات النظرية، وأن يكون مستوعباً لنصوص وقضايا دينية كثيرة، جيِّد الشرح لها، والإبانة عنها.. حتى إذا محص بالتكليف الشاق أو المعاملة الجادة تكشف عن إنسان آخر لا فقه له ولا وعي عنده، فهو كما قال المعري:
سبِّح، وصلِّ، وطف بمكة زائراً سبعين، لا سبعاً، فلست بناسك
جهل الديانة من إذا عرضت له.. أهواؤه لم يلف بالمتماسك!..
وللمرحوم أحمد أمين وصف كاشف لهذه الآفة، وقيمة أصحابها، وكيف يخلصون منها، كتبه من ربع قرن، وكأنّما كتبه الآن، يقول: "من عجيب الأمر أن كل شيء في الوجود يعمل وفق طبيعته، ويوافق بين ظاهره وباطنه، وتصدر أعماله منسجمة مع خلقته، ويعبِّر دائماً عن جبلته، سواء في ذلك الجماد والنبات والحيوان، إلا الإنسان، فإنّه هو الذي يستطيع أن يخدع، وأن يظهر على غير طبيعته، وأن يقول غير ما يعتقد، وأن يفعل غير ما يقول.
الحجر والحديد والرصاص كل منها يُعبِّر عن طبيعته، وهو يُعبِّر عنها دائماً في صدق.
وأشجار الورد والتفاح والحنظل تُعبِّر عن طبيعتها في صدق دائماً، وتنتج ثمارها من جنس طبيعتها دائماً، ولا تخرج شجرة التفاح حنظلاً يوماً ما.
والفرس والجمل والبقر تعبِّر عن طبيعتها في صدق دائماً، فإذا أبدت رغبة في الأكل أو الشبع، أو نحو ذلك، فهذا حق لا مرية فيه.
أمّا الإنسان، فلا يعبِّر عن حقيقته دائماً، فقد يعبِّر عن جوعه وهو متخم، وعن حبّه وهو كاره، وعن إخلاصه وهو يخفي الإجرام، وعن حبّه للشيوعية والإشتراكية وهو رأسمالي جشع.
فكل شيء هو نفسه إلا الإنسان، فكثيراً ما يكون غير نفسه، حتى قال كاتب ظريف: "إنّ اللغة لم تُخترع للتعبير عن النفس، ولكن لإخفاء ما في النفس، والتمويه على الناس حتى لا يدركوا حقيقة ما في النفس".
"... وممّا يؤسف له أنّ الإنسان كلما كان أذكى وأمهر وألبق كان أبعد عن أن يعبِّر عن نفسه، وعن أن يكون هو نفسه، وكلما كان أقرب إلى الغفلة والسذاجة كان أقرب إلى أن يكون هو نفسه وأن يعبِّر عما في نفسه.
ليست قيمة الإنسان فيما يصل إليه من حقائق وما يهتدي إليه من أفكار سامية، ولكن في أن تكون الأفكار السامية هي نفسها، وهي عمله، وهي حياته الخارجية كما أنّها حياته الداخلية.
فقد يكون الإنسان فيلسوفاً كبيراً وهو – في الوقت عينه – نذل خسيس حقير، كالذي روى لنا عن (بيكون) الفيلسوف الإنجليزي الكبير.
وقد يحدِّثك الرجل عن أضرار الخمر والقمار، فيمتعك بحديثه ويصف لك ذلك أجمل وصف وأدقّه وهو، مع ذلك، سكير مقامر، لأنّه في أفكاره غيره في أعماله، وبعبارة أخرى هو لا يحقِّق نفسه ولا يعبِّر عن نفسه.
فالفكر بلا عمل مناقشات بيزنطية، أو بحوث جامعية، أو العاب بهلوانية، إنّما قوة الفكر وأحقيتها بتحويلها إلى عمل ووضعها موضع التجربة.
وإذا اعتقدها الإنسان، فمعناه أن يعمل بها، وإذا دعا إليها، فمعناه أنّه جرّبها في نفسه بنفسه فوجدها صالحة، وما عدا ذلك فشقشقة ألفاظ، وملء مجالس، وإظهار تظرف، ومباهاة بالقوة العقلية، أو القدرة الجدلية، ومقدمة بلا نتيجة!!
كيف نحوِّل الفكر إلى عمل؟ وكيف نمنع الفكر من أن يتبخّر؟ وكيف لا نفكِّر إلا إذا ضمّنا العمل بما نفكِّر؟
إنّ الفكرة ميتة ما لم يحيها العمل.. خيال ما لم يحقِّقها العمل.. ولا عبرة بصحّة الفكرة أو خطئها إذا ظلّت في عالم التفكير المجرد، بل إنّ الفكرة إذا احتوت على خطأ أظهره العمل، خير من الفكرة التي يثبت صحّتها المنطق ولا تتحوّل إلى عمل".
"هذه هي الحقيقة التي نريد تقريرها، ولا أحسب أحداً يخالف في ضرورتها..
ترى أتكون هذه هي الحقيقة التي أكثر في الحديث عنها المتصوّفون؟ إنّ ذلك يحتاج إلى شرح مستفيض.
على أيّة حال، يجب أن تتضافر الجهود لدفع المسلمين إلى هذه السبيل، سبيل العمل الذي يملأ القلب، ويزحم الحياة".
عندما نقرأ تراثنا، ونستقري ماضينا، ندرك للتو أنّ ما بناه مهندسو التراث والحضارة العربية الإسلامية لا ينبغي أبداً أن ينتهي بها المآل لتكون:
كدود القزّ ينسج ثمّ يفنى بمركز نفسه في الإنعكاس
أولئك الذين تمخّضت قرائحهم الفذّة عمّا وصلنا من تراث أفكارهم، كانوا قوماً آمنوا بجسامة مسؤولياتهم الجديدة، فحلبوا الدهرّ أشطرَه، واستوفوا من العلم أوفره.
آمن أولئك الروّاد العظام أنّ الإيمان والعلم خير في ذاتيهما. آمنوا أنّ الإيمان والعلم للحكمة منجيان (... ومَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً...) (البقرة/ 269).
كان أولئك الجهابذة في العلم والمعرفة مهندسي ثقافة وصانعي حضارة: فكانوا في الأقل بسنا نورين يهتدون:
أوّلاً: نور الإيمان يشعّ في قلوبهم فيرون من خلاله معجزات الكون، فنور الإيمان أبهى وأسنى.
ثانياً: نور البصائر والأبصار، فهو نور به الوجدان يحيا، نور الكيان الإنساني كلّه.
فبهذا تمكّنت تلك الثلّة المباركة من التفوق والإبداع. فجاءت أفكارهم، باجتهادها وعلمها، واسعة سعة العوالم التي انتشر فيها، ورحيبة رحابة الآفاق التي راودها.
فكيف يتسنّى للمهتم بهذا الفكر وما أبدعه من تراث سامق أن يرتاد كل شعابه، وما أكثرها؟
وكيف يتأتّى لدارس هذا المضواء وما قدّمه للإنسان من معرفة بنّاءة وثقافة وضّاءة، أن يلمّ بأهداب دقائقه وبكل حقائقه؟
وكيف يتيسّر لباحث توّاق لخوض عباب هذا التراث أن يجوب دفائن معطياته ليخلص إلى نهايات منعطفاته؟
أفلا يخلق بنا أن نقرأ هذا التراث الخالد قراءة جديدة؟
أن نقرأه بعين روح العصر الجديد، لنعتبر من ناحية، ومن ناحية ثانية لعلنا نضيف شيئاً نماهي به غيرنا ممّن قدّموا في زماننا هذا من الإختراعات والإكتشافات ما يدهش؟
فكم من أمّة سجّلت ماضيها، واستقرأت تراثها، واستشرفت مستقبلها، فنفضت ما ران عليها من غبار عوادي الزمن، فاستفاقت متجددِّة مجدِّدة.